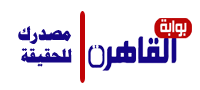حروب من نوع خاص

كانوا زمان بيقولوا الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق، أما الآن إذا أردت أن تهدم أمة عليك بالمرأة، إذن ما هو الإختلاف بين الجملتين؟.
زمان كنا بنزرع في بناتنا مسؤلية ضخمة والكل يعلم مدى خطورتها وهي بناء الأجيال، وكانت تُعد أخلاقيًا ودينيًا قبل إعدادها علميًا، وكان المراد من تعليم المرأة أن تساعد الأطفال في عمليات التحصيل العلمي.
أما التي لم يصبها الحظ في التعليم كانت أحرص مايكون على إخراج جيل قادر على حمل رآية العلم والأخلاق، فنبت من بين أيديهن العظماء في كل مجال، فغزو العالم بعلومهم، بل وأخلاقهم.
أما الآن وقد اكتسبت بناتنا الكثير من المميزات والصفات والتفوق في كل مجال، حتى أصبحت تنافس الرجل في كل مجلات الحياة وأصبحت الطبيبة والوزيرة والمهندسة، بل ايضًا أصبحت تنافسه في مجال الحرف الصناعية مثل السباكة وغيرها.
والآن أصبح لدينا جيل يلقي بعرض يديه حياته الأسرية، لأنها تتعارض مع طموحه، فأصبحت “الأنانية”، سيدة الموقف بعدما كنا شمعة تحترق من أجل الجميع، نتسأل جميعًا عن مدى تدهور الأخلاق في تلك الأيام؟
ربما أكون قاسيةً على نفسي وجنسي، ولكن نحن النساء مسئولات عن هذا التدهور، أصبحنا نلهث وراء كل ما هو يلاصق كلمة تطور وتحضر وتمدن، دون النظر والفهم، هل هذا يوافق مجتمعاتنا، أم تلك الكلمات سهامًا مصوبةٍ في قلوبنا ومجتمعاتنا؟.
لا انُكر دور الرجل في إتساع الفجوة، فبُعده عن مسئولياته، ما كان للمرأة إلا أن تسعى لسد تلك الفجوة على حساب بيتها وأبنائها.
كنت أتمنى أن يقف الزمان بي إلى عهدًا كنت أُقبل فيه رأس أبي ويد أمي، ومن نظرة أعيُنهم التمس الحب والحنان، ونسعى بالإجتهاد لكسب لمسة الرضى ودعاءهم المستحاب.
بقلم| سحر سلام